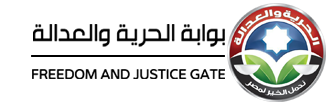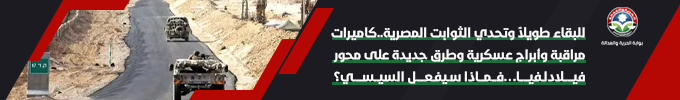يفرد بنيامين نتنياهو خريطة الشرق الأوسط على مائدة الدم، يقسّم البلاد ويرسم الحدود، ويوزع السكّان كما يشاء. هو منذ البداية مهووسٌ بأسطورة أنه "ملك إسرائيل"، التي هي في مفهومه مالكة المنطقة بالوراثة عن تلال من الأكاذيب التاريخية المنقوعة في أوهام الصهيونية الدينية وأساطيرها.
لا يتحكّم نتنياهو بالشرق الأوسط جغرافياً وديموغرافياً فقط، بل صار يوزّع حصص الثروات الطبيعية في المنطقة، مانح الغاز لمن يرضى عنه ويراه الأولى بالرعاية، وموزّع الأدوار في إدارة الأراضي التي ينوي احتلالها، فيعلن، بكلّ ثقةٍ، إنه سوف يحرّر غزّة من حركة حماس، ويسند إدارتها إلى دول عربية لا تهدّد إسرائيل، ثمّ يأتي إعلان أكبر صفقة غاز طبيعي في التاريخ (35 مليار دولار) تمنحها تل أبيب إلى القاهرة، فتشتعل بعدها مباشرةً منابر الإعلام الرسمي المصري بالهجوم على المقاومة الفلسطينية، وتحميلها المسؤولية عن تدمير غزّة وقتل شعبها وإبادته، ثمّ يرتفع سقف الجنون المتصهين ليصل حدّ اعتبار فصائل المقاومة دخيلةً على فلسطين وعلى المنطقة، بالتزامن مع مهرجانٍ احتفاليٍّ هادر بنجاح الحكومة المصرية في إنجاز الصفقة، التي ستأتي بالخير والرخاء والنماء، وكأن مصر باتت "هبة الغاز الإسرائيلي".
ثمّة ما يبدو أنه إذعان رسمي عربي لهلاوس نتنياهو وأكاذيبه وأساطيره، وكأنه صار"السيد الأصلي الوحيد" في الشرق الأوسط، بينما الجميع مستنسخون أو مستحدثون أو وافدون على المنطقة، وإلا ما هو التفسير العقلاني والمنطقي لكرنفال الفرح المصري بتعميق التعاون مع الاحتلال في مجال الطاقة؟ وما هو المنطق الذي يدفع لبنان الرسمي إلى وضع رقبته، سعيداً مبتسماً محتفلاً بالنجاح، في يد الإدارة الأميركية، التي تبدو صهيونية التوجّهات والغايات، أكثر من صهاينة إسرائيل أنفسهم؟ ما الذي يجعل وطناً مقاوماً اسمه "لبنان الكرامة" يستقبل الورقة الأميركية كأنها نصّ مقدّس نزل من السماء للتو، يقول إن المقاومة رزيلة وخطيئة، وإن في السلاح المرفوع في وجه العدو هلاك للبلاد، وإن لا مناص من أن تنفيذ كلّ أوامر نتنياهو وأحلامه كي يعيش لبنان في كنف الشرق الأوسط الإسرائيلي؟
ما الذي يمكن أن يبرّر صمت سورية عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على سيادتها، وضمّها مناطق جديدة إلى جانب الجولان المحتل، واعتبارها السويداء وشعبها ضمن رعاياها وتحت حمايتها؟ ما الذي يبرّر هذا السخاء الخليجي المنهمر على إدارة دونالد ترامب، التي يربطها بالاحتلال الصهيوني حبل سُرّي يجعلهما كياناً واحداً، في وقتٍ يموت الشعب الفلسطيني جوعاً؟ ما الذي يجعل الدوائر الرسمية والإعلامية المصرية ترى في إلقاء بعض المساعدات جواً، بأمر نتنياهو وإذنه، لتسقط على رؤوس الفلسطينيين، إنجازاً سياسياً وعسكرياً مصرياً، يؤكّد الريادة في النضال من أجل القضية الفلسطينية؟ وما المنطق في اعتبار مرور بعض شاحناتٍ من معبر كرم أبو سالم، الذي تهيمن عليه إسرائيل هيمنة مطلقة، بطولةً في وقت جعلت معبر رفح المصري الفلسطيني محرّماً على السلطات المصرية؟
الشاهد أن ثمّة استسلاماً عربياً كاملاً للدخول فيما أسميتُها مرحلة تمزيق الخرائط ومحو الفواصل وإذابة الحدود، كما حلم بها شيمون بيريس قبل أكثر من ربع قرن، حين رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد، في أنوار "كامب ديفيد" (1978)، ثمّ "أوسلو" (1993)، تلك الرؤية التي ضمّنها كتابه الأشهر، وفيها حتمية المشروع الواحد الذي تتشارك فيه إسرائيل والدول العربية، داعياً الجميع إلى التحرّر من قيود التاريخ والجغرافيا، والانخراط في التصوّر الصهيوني للمنطقة.
من كان يتصوّر أن أحلام بيريس القديمة سوف لن تُشبع جوع إسرائيل الجديدة بعد ربع قرن، إذ يتجاوز ما حققه نتنياهو في أرض الواقع أسوأ كوابيس الشعب العربي وأبعد من أحلام الصهاينة الأُوَل، لنصل إلى لحظة يقول فيها مصطفى الفقّي (سكرتير حسني مبارك السابق ورجل عبد الفتاح السيسي الحالي) في الشهور الأولى من العدوان الصهيوني على غزّة: "لا نريد شيئاً يعكّر صفو المنطقة والتعايش المشترك مع إسرائيل"، ثمّ يضيف في مقابلة تلفزيونية: "التابو بياخد أجيال، وأحفادك بإذن الله هيتعاملوا مع أحفاد الإسرائيليين في محبّة وصفاء بشرق أوسط مختلف… ندعو الله".